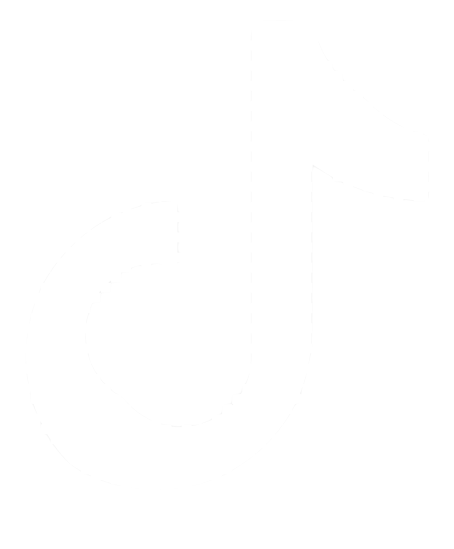بين الحياد والموضوعية في العلوم السياسية: هل يمكن للباحث أن يفصل بين الموقف والمنهج؟

المعركة الحقيقية في الحقل السياسي ليست بين “الانحياز والحياد”، بل بين التحليل العميق المبني على الأدلّة، وبين السرديات السطحية القائمة على المواقف المسبقة أو الحذر المفرط.
كتب جو أندره رحال لـ”هنا لبنان”:
في خضم النقاشات الفكرية التي ترافق تطوّر العلوم السياسية كحقل معرفي متداخل مع الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع، يبرز سؤال جوهري يُعاد طرحه مرارًا: هل يمكن للباحث السياسي أن يكون حياديًا؟ وهل تعني الموضوعية بالضرورة حيادًا؟ وما الفارق الدقيق بينهما؟ هذه الأسئلة ليست مجرّد ترف أكاديمي، بل ترتبط جوهريًا بجوهر المنهج البحثي، وموقع الباحث من القضايا التي يدرسها، خاصةً في مجتمعات منقسمة سياسيًا أو تعيش أزمات وجودية، كحال العديد من الدول في الشرق الأوسط.
الحياد (Neutrality) يُفهم عادةً على أنّه الامتناع عن اتخاذ موقف مؤيد أو معارض تجاه قضية ما، أي أن يبقى الباحث بمنأى عن الانحيازات السياسية أو الإيديولوجية. هذا التعريف يبدو سهلًا للوهلة الأولى، لكنّه يصطدم بمعضلة أساسية: هل يمكن فعليًا لأي إنسان – بما في ذلك الباحث – أن يكون محايدًا بالكامل؟ الجواب، بحسب معظم الفلاسفة والمنهجيين، هو: لا. فحتّى اختيار موضوع البحث، وتحديد الإشكالية، وصياغة الفرضيات، جميعها محكومة مسبقًا بمنظومة القيم والتصوّرات الشخصية أو الثقافية أو البيئية التي يتحرّك ضمنها الباحث.
أمّا الموضوعيّة (Objectivity)، فهي مفهوم أكثر عمقًا واتساعًا. لا تعني الموضوعية أن يتجرّد الباحث من ذاته أو من قِيَمِهِ، بل أن يُدرك هذه القيم جيدًا ويسعى لتطويق أثرها خلال التحليل العلمي. المفكّر الألماني ماكس فيبر (Max Weber) شدّد على هذه النقطة من خلال طرحه لفكرة “التحليل الخالي من القِيَم” أو (Value-free sociology)، مؤكدًا أنّ الموضوعية لا تعني غياب القيم، بل إدراكها وتحويلها إلى موضوع للتحليل لا محرّك للتحيّز. بهذا المعنى، تُصبح الموضوعية منهجًا علميًا يركّز على التوثيق والتحليل والتفسير القائم على الأدلة والوقائع، لا مجرّد موقف حيادي من القضايا.
الخلط بين المفهومَيْن يؤدّي إلى إرباك كبير، خصوصًا في أوساط الصحافة السياسية أو الدراسات الميدانية. فالموضوعيّة قد تقود إلى نتيجة “غير محايدة” إذا ما قادت البيانات إلى تحميل طرف سياسي مسؤولية ما. على سبيل المثال، إذا أظهر تحليل سياسي علمي أن نظامًا سياسيًا مُعيّنًا يقمع الحريات بشكل ممنهج، فإنّ قول ذلك لا يتعارض مع الموضوعية، حتى لو فُسِّر على أنه انحياز. الحياد هنا يُخفي الحقيقة، بينما الموضوعية تكشفها.
الباحث السياسي لا يُطلب منه أن يكون “روبوتًا”، بل أن يكون منهجيًا، واعيًا لانحيازاته، متحكّمًا بأدواته، ملتزمًا بالدقّة والتوثيق، وقادرًا على توضيح منهجيّة تفكيره. في المقابل، الحياد بوصفه موقفًا سياسيًا أو إعلاميًا يمكن أن يكون مطلوبًا في بعض الحالات (كوسيط دولي أو مراقب دولي للانتخابات)، لكنّه في البحث العلمي قد يتحوّل إلى شكل من أشكال الإنكار أو التواطؤ الصامت، خصوصًا في القضايا التي تمسّ حقوق الإنسان، أو تكشف عن فساد ممنهج، أو عنف سلطوي.
منهج السلوكيّة (Behavioralism) في العلوم السياسية، والذي ازدهر في خمسينيّات وستينيّات القرن العشرين، حاول تعزيز فكرة “التحليل الموضوعي” عبر استخدام أدوات كمية وتجريبية بعيدًا عن القيم والتفسيرات الإيديولوجية. لكنه واجه انتقادات لاحقًا لأنه غضّ الطرف عن البُعد القيمي للأفعال السياسية، ما أظهر محدوديّته في تفسير الظواهر المركبة كالثورات أو الهويات السياسية أو الصراعات الطائفية.
خلاصة القول، الحياد والموضوعيّة ليسا مترادفَيْن. الحياد موقف، والموضوعية منهج. الحياد قد يكون ضروريًا في الإعلام أو الوساطة أو القانون، لكنّه في العلوم السياسية لا يجب أن يتحوّل إلى عائقٍ أمام قول الحقيقة. الباحث الموضوعي لا يخشى أن يُظهر نتائج بحثه، حتى لو كانت “غير محايدة” في ظاهرها، طالما أنّها مستندة إلى معطيات واضحة وتحليل متماسك. أمّا الباحث الحيادي بالمطلق، فقد يسقط في فخ التضليل أو تغييب الحقائق.
من هنا، فإنّ المعركة الحقيقية في الحقل السياسي ليست بين “الانحياز والحياد”، بل بين التحليل العميق المبني على الأدلّة، وبين السرديات السطحية القائمة على المواقف المسبقة أو الحذر المفرط. الباحث النزيه ليس محايدًا، بل صادقًا، شفّافًا، ومؤمنًا بأنّ قول الحقيقة بموضوعية هو أعلى درجات الالتزام العلمي والأخلاقي.