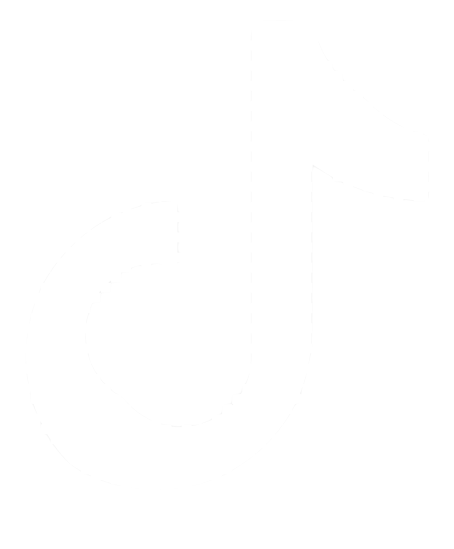صندوق النقد “يؤدّب” العالم بالمودع اللبناني… تشريح مفصّل لأخطر قانون في تاريخ لبنان

ما قدّمته الحكومة تحت عنوان “قانون الفجوة المالية” ليس مجرد تشريع مالي، بل نص يؤسّس للمشهد الاقتصادي الذي سيلي إقراره. قانون لا يُخفي غايته، بل يعلنها بهدوء: إقفال أزمة عمرها سنوات بدل حلّها، شطب الودائع بدل استعادتها، وتبرئة الدولة والمصرف المركزي، ولو على حساب النظام المصرفي والمودعين معًا. هكذا يتحوّل المودع اللبناني إلى أداة “تأديب” في نموذج يُراد تعميمه، لا إلى صاحب حق يُفترض حمايته.
من يقرأ هذا القانون مادةً مادة، يدرك سريعًا أن الحكومة لم تضع خطة إنقاذ، بل وضعت إطارًا قانونيًا يُشرّع أخطر مسار مالي في تاريخ لبنان. مسار يضرب حق الملكية في الصميم، يشرّع الإفلاس الجماعي للمصارف، ويقضي على أي إمكانية لإعادة بناء نظام مالي سليم، دافعًا البلاد نحو اقتصاد نقدي مفكّك بلا ثقة وبلا قطاع مصرفي، وكل ذلك تحت عنوان “الإصلاح” وامتثالًا لإملاءات خارجية لا علاقة لها بحماية حقوق اللبنانيين.
في جوهره، يعكس المشروع خيارًا سياسيًا واضحًا: التماهي الكامل مع مقاربة صندوق النقد الدولي، والتخلّي عن أي مقاربة سيادية. الدولة التي راكمت الدين، موّلت العجز، ثبّتت سعر الصرف، بدّدت المال العام، ثم تخلّفت عن سداد ديونها، تُخرج نفسها من دائرة المحاسبة. لا مساهمة إلزامية من ميزانيتها، ولا تحمّل مباشر لكلفة الانهيار. بل تكتفي، وفق ما ورد في الباب الخامس، بالاعتراف “من حيث المبدأ” بوجود دين لمصرف لبنان، على أن يُحدَّد حجمه وشروطه لاحقًا بما يراعي ما تسميه “استدامة الدين العام”، أي بما يناسب الدولة لا بما يفرضه الحق.
هذا وحده كافٍ لإسقاط كل خطاب حكومي عن تحمّل المسؤولية. فالدولة، في هذا القانون، ليست طرفًا ملزمًا، بل جهة تفاوض على حجم مسؤوليتها وفق قدرتها السياسية والمالية، لا وفق حجم الضرر الذي تسببت به للاقتصاد والمجتمع.
أما مصرف لبنان، فيخرج من القانون بحصانة شبه مطلقة. فعلى الرغم من اعتراف الأسباب الموجبة بأن السياسات النقدية للمصرف المركزي ساهمت في تدهور جودة أصوله وعجزه عن الإيفاء بالتزاماته تجاه المصارف، يتجنّب المشروع تطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تُلزم الخزينة بتغطية خسائر المصرف المركزي، ويحوّل هذا الإلزام الصريح إلى “خيار” للحكومة، في مخالفة فاضحة لقانون نافذ وواضح.
وعندما تُعفى الدولة ويُحصَّن المصرف المركزي، لا يبقى في المشهد سوى المصارف والمودعين.
القانون، وخصوصًا في الباب السادس (المواد 11 إلى 14)، يرسم هذا المسار بوضوح لا لبس فيه: الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار لا تُعاد نقدًا، بل تُحوَّل إلى “شهادات مدعومة بأصول” صادرة عن مصرف لبنان، تستحق بعد 10 أو 15 أو 20 سنة، بفائدة متدنية، ومن دون أي ضمانة فعلية سوى إيرادات مستقبلية غير مؤكدة للمصرف المركزي.
عمليًا، هذا ليس استردادًا للودائع، بل استبدال لحق الملكية بأداة مالية مجهولة القيمة. فلا أي محاكاة واضحة لإيرادات الأصول، ولا تحديد لكيفية استخدام الذهب المحمي بقانون، ولا شرح لكيفية تغطية هذه الالتزامات في ظل شح السيولة. والأسوأ أن الاحتياطي الإلزامي، وهو حق للمودعين، يُستخدم كأنه “مساهمة” من مصرف لبنان، في قلب كامل للوقائع.
الأخطر أن القانون لا يكتفي بشطب الودائع مقنّعًا، بل يذهب إلى تجريم المودعين أنفسهم. ففي الباب الثالث، وتحديدًا في المادة الخامسة، تُعاد فتح التحويلات التي جرت بعد 17 تشرين الأول 2019 وتُعامل كأنها مشبوهة، رغم أنها كانت قانونية وبموافقة مصرف لبنان. كما يجرّم المشروع الاستفادة من فوائد مصرفية مشروعة منذ 2016، ويطالب بردّها، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم رجعية القوانين وللحقوق المكتسبة. أي قانون هذا الذي يعاقب المواطن لأنه التزم بعقد وقانون وتعاميم رسمية؟
وبموازاة ضرب المودعين، يضرب القانون القطاع المصرفي من جذوره. فهو يبدأ بشطب الرساميل بالكامل، ثم يطلب إعادة الرسملة، ويحمّل المصارف في الوقت نفسه 20 بالمئة من كلفة شهادات طويلة الأجل. أي مصرف يمكن أن يصمد تحت هذا العبء الممتد لعقود؟ وأي مستثمر يمكن أن يضخ أموالًا في قطاع حُكم عليه القانون مسبقًا بالإفلاس؟
المفارقة القاتلة أن الأسباب الموجبة تعترف صراحة بأن الأزمة نظامية، وبأن الدولة ومصرف لبنان شريكان أساسيان فيها، لكن هذا الاعتراف يُستخدم لتبرير نقل الخسائر إلى المودعين والمصارف، وتبرئة المسؤولين الفعليين.
وفي الخلفية، قرر صندوق النقد الدولي أن يوجّه رسالة قاسية إلى المصارف المنغمسة في تمويل الدول، لا من باب الإصلاح، بل من باب الردع. فالصندوق لا ينظر إلى لبنان كحالة معزولة، بل كجزء من مشهد عالمي أوسع، يرى فيه أن المصارف باتت المموّل الأساسي للدول عبر الاكتتاب المكثّف بسنداتها السيادية. ومن هنا، تأتي المقاربة العقابية: على المصارف أن “تنتبه” عندما تُقرض الدول، لأن الثمن قد لا تدفعه الدولة المتخلّفة عن السداد، بل المصارف نفسها ومعها المودعون. في هذا السياق، لا يُعامَل لبنان كاستثناء، بل كنموذج يُراد تعميمه بهدوء، نموذج لكيفية معاقبة المصارف ومودعيها من دون الاعتراف صراحة بأن الدولة المفلسة هي المسؤولة الأولى عن الانهيار، ومن دون الإعلان علنًا أن ما يجري في لبنان هو سابقة يُراد تمريرها على مراحل.
وإذا ما أُقِرّ هذا القانون بصيغته الحالية، فالنتيجة محسومة: إفلاس جماعي للقطاع المصرفي وضياع منظّم لأموال المودعين. شطب الرساميل، الأعباء الطويلة الأجل، ومنع إعادة الرسملة، كلها تقود حتمًا إلى سقوط المصارف واحدًا تلو الآخر، تحت غطاء تشريعي يمنح هذا الانهيار صفة “الإصلاح”.
في هذا المشهد، لا تعود الودائع حقوقًا بل أرقامًا دفترية بلا قيمة، ولا يعود الحديث عن حماية اجتماعية سوى وهم. أما الدولة، فتقف متفرّجة بعد أن منحت نفسها إعفاءً قانونيًا، فيما يخرج مصرف لبنان بأرقام “نظيفة” بعد تحميل الخسائر للناس.
في الخلاصة، ما أعدّته الحكومة ليس قانون إنقاذ، بل قانون تصفية: تصفية للقطاع المصرفي، تصفية لودائع الناس، وتصفية لمبدأ الدولة كضامن للحقوق. الهدف واضح: تقديم ميزانية “مرتّبة” لصندوق النقد الدولي مهما كانت الكلفة.
وأي حكومة تُقرّ هذا القانون لا ترتكب خطأً تقنيًا، بل تتخذ قرارًا سياسيًا تاريخيًا بتشريع أكبر عملية مصادرة للودائع في تاريخ لبنان.
هذا هو المشهد النهائي الذي يرسمه القانون.
وهو مشهد لا يشبه الإنقاذ بشيء.
المصدر: موقع ليبانون ديبايت