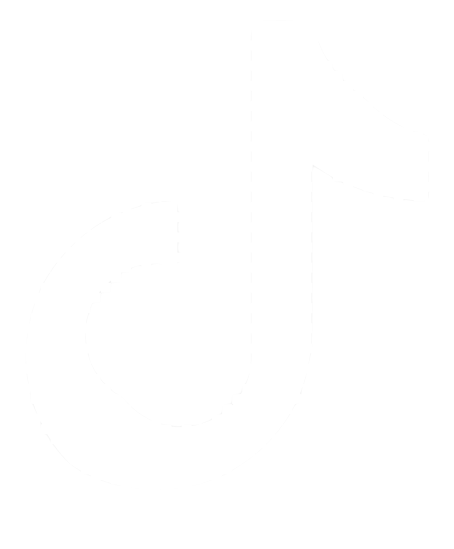“وسيط الجمهورية”: جسر مكسور بين المواطن والدولة

إنّ العدالة الإدارية ليست ترفًا قانونيًا، بل ركيزةً للاستقرار وثقة الناس. إبقاء قانون الوسيط مجمّدًا منذ 2005 ليس مجرّد تأخير إداري، بل فعل سياسي يُعبّر عن تهرّب السلطة من أي شكلٍ من أشكال المحاسبة. أمّا تفعيله وتحديثه رقميًا، فهما الطريق الضروري لإصلاح الإدارة، واستعادة العلاقة الطبيعية بين المواطن والدولة.
كتب جو أندره رحال لـ”هنا لبنان”:
في دولةٍ تتعدّد فيها النصوص وتتقلّص فيها الإرادة، لا يبدو غريبًا أن يبقى قانون “وسيط الجمهورية” رقم 644، الصادر في 4 شباط 2005، حبيس الأدراج منذ ما يقارب العقدَيْن. هذا القانون، الذي ينصّ على إنشاء هيئةٍ مستقلةٍ لتلقّي شكاوى المواطنين ضدّ الإدارات العامة والمؤسّسات الرسمية، يُمثّل في جوهره محاولةً لبناء مسار عدالةٍ إداريةٍ خارج الإطار القضائي المعقّد، ووسيلةٍ لاستعادة شيء من الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. ومع ذلك، لا تزال هذه المؤسّسة غائبة بالكامل، وكأنّ العدالة الإدارية ليست أولوية.
ينصّ القانون بوضوح على أنّ “وسيط الجمهورية يعمل كجهةٍ غير قضائيةٍ، تتابع التظلّمات الإدارية وتُصدر توصياتها إلى الجهات المختصة، بهدف تصحيح الأداء الإداري ومعالجة التجاوزات التي يتعرّض لها الأفراد”. إلّا أنّ تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تعيين الوسيط، وعدم تخصيص الموازنة التشغيلية اللازمة، يكشف بوضوحٍ أنّ المشكلة ليست قانونيةً، بل سياسية. فالمنظومة الحاكمة، التي ترعى “الزبائنية” وتتهرّب من الرقابة، لا تجد مصلحتها في تفعيل مؤسسة رقابية مستقلة تُسلّط الضوء على خلل الإدارة.
وقد أُدرج القانون ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020–2025)، كما حظيَ بدعمٍ تقنيّ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لكن بقي التنفيذ مُعطّلًا. مجلس النواب لم يُدرجْه في أي جلسةٍ تنفيذيةٍ، والحكومة لم تتّخذ أي خطوات عملية لوضعه موضع التنفيذ، في مشهدٍ يعكس الفجوة العميقة بين الالتزامات المُعلنة والممارسة الفعلية.
في المقابل، تُظهر تجارب دول مثل فرنسا وكندا والمغرب فعّالية مؤسّسات الوسيط في معالجة الخلافات الإدارية، وتخفيف العبء عن القضاء، وترسيخ الشفافية. ففي فرنسا، يُشكّل “مدافع الحقوق” مرجعيةً وطنيةً مستقلةً لحماية المواطن من أي تعسّف إداري. أمّا في المغرب، فقد ساهمت مؤسّسة الوسيط في فَضِّ آلاف النزاعات بين الأفراد والمؤسّسات، وأصبحت حلقةً أساسيةً في بناء ثقافة الإنصاف الإداري.
لكنّ لبنان لا يُعاني فقط من غياب التفعيل، بل من تخلّفٍ تشريعيّ في مواكبة العصر. ففي زمن الرقمنة، لا يمكن تصوّر عدالةٍ إداريةٍ فعّالةٍ من دون بنية رقمية ذكية. من هنا، تُصبح الحاجة إلى تحديث قانون الوسيط ضرورةً موازيةً لتفعيله. فبدل الاكتفاء بالآلية التقليدية لتقديم الشكاوى، يجب العمل على إنشاء “وسيط إلكتروني” أو “وسيط ذكي” يعتمد الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى وتصنيفها وتتبّع معالجتها.
هذه المنصّة الرقمية يمكن أن تُشكّل نقلةً نوعيةً، تسمح بتلقّي الشكاوى على مدار الساعة، وتُتابع الردود المؤسّسية آليًا، وتُنتج تقارير فورية عن أنماط الفساد الإداري وتكرار المخالفات. بذلك، يتحوّل الوسيط من مجرّد هيئة استشارية إلى منظومة تفاعلية تضع المواطن في قلب الرقابة، والدولة في مرآة مستمرة للمحاسبة.
إنّ العدالة الإدارية ليست ترفًا قانونيًا، بل ركيزةً للاستقرار وثقة الناس. إبقاء قانون الوسيط مجمّدًا منذ 2005 ليس مجرّد تأخير إداري، بل فعل سياسي يُعبّر عن تهرّب السلطة من أي شكلٍ من أشكال المحاسبة. أمّا تفعيله وتحديثه رقميًا، فهما الطريق الضروري لإصلاح الإدارة، واستعادة العلاقة الطبيعية بين المواطن والدولة. فحين تكون الشكوى مسموعةً، تُصبح الدولة مسؤولةً؛ وحين تُحاسَب الإدارة، تعود الثقة؛ أمّا حين يُمنح المواطن وسيلةً رقميةً وعادلةً للاعتراض، يبدأ الإصلاح من مكانه الصحيح.