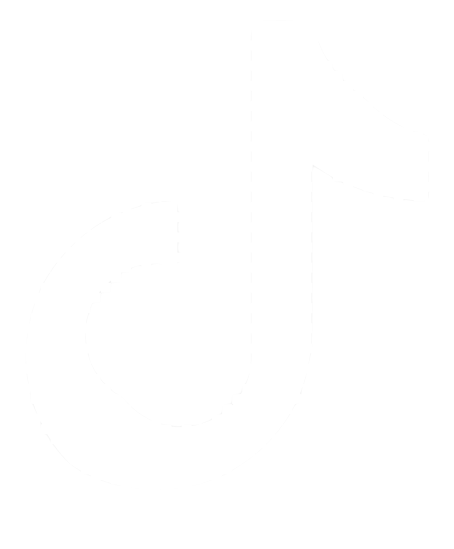سقوط الأسد ورفع العقوبات عن سوريا: هل يطوي لبنان صفحة النزوح؟

كتبت Natasha Metni Torbey لـ”Ici Beyrouth”:
قد يغير القرار الأميركي المفاجئ برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بعد فترة قصيرة من سقوط نظام بشار الأسد، بشكل جذري من طريقة التعاطي مع ملف النازحين السوريين في لبنان.. إلا أنّه لم يضمن قرارعودتهم النهائية أصلاً في إطار “الصفقة” التي تعمل عليها الأطراف المعنية.
سياق الحدث
في خطوة قلبت موازين المنطقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثالث عشر من أيار، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية بالكامل عن سوريا، واضعاً بذلك حداً لأكثر من عقد من العزلة الاقتصادية المفروضة على دمشق. هذا التحول الجذري يأتي على بعد أشهر قليلة من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول 2024، بفعل موجة مزدوجة من النقمة الشعبية ومن تخلي آخر داعميه الدوليين.
وفي لبنان، ترك هذا التطور الجيوسياسي وقعاً فوريًّا ومُلِحًّا وطرح تساؤلات جدية. فما هو مصير نحو 1.5 مليون نازح سوري يقيمون على الأراضي اللبنانية؟ مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام الرسمية متحفظة مقارنة بتقديرات خبراء يرجحون أن العدد الفعلي يتجاوز المليوني سوري في لبنان؟ وماذا عن آليات الدعم الإنساني التي كانت تؤمّن لهم مقومات الحياة؟ هل ستستمر أم أن المتغيرات الجديدة ستفرض واقعاً مغايراً؟
نهاية ذريعة دبلوماسية؟
وعلى مدى سنوات طويلة، اعتمدت منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة والعديد من العواصم الغربية الذريعة نفسها: طالما أنّ سوريا ترزح تحت حكم استبدادي وتخضع لعقوبات دولية، لا تُعدّ عودة النازحين إليها آمنة ولا كريمة ولا مستدامة. وشكّلت هذه الذريعة الأساس لبرامج الدعم الإنساني الضخمة، خصوصاً في لبنان.
ولكن هذا الأساس بدأ بالانهيار اليوم. “ما عاد هناك من مبرر، لا إنساني ولا اقتصادي ولا سياسي ولا قانوني، لإبقاء هذه الفئات في دول اللجوء، ولبنان ضمناً”، حسب مصدر مطلع على الملف. وأضاف أنّ “سقوط النظام ورفع العقوبات يعني أن طريق العودة باتت مفتوحة تقنياً وسياسياً”.
ما هي المبررات؟
بادئ ذي بدء، لم يعد ما كان يصنف “خطراً” سياسياً وأمنياً، قائماً. ويدرك الجميع جيداً أنّ حركة تنقّل السوريين بين دمشق وبيروت لم تتوقف يوماً حتى في أوج الحرب، وفي ظل حكم الأسد نفسه. ولطالما حصلت هذه التنقلات أمام أعين المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية، التي اختارت لسنوات طويلة غضّ الطرف عنها، لأسباب باتت معروفة لدى الجميع.
ومن جملة الأسباب أيضاً، أنّ المليارات التي صبّتها المؤسسات والمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها المفوضية الأوروبية، في لبنان خلال السنوات الماضية، لم تكن بريئة أو عشوائية. ذلك أنّ أوروبا كانت تعيش آنذاك هاجساً وجودياً حقيقياً من موجات الهجرة غير الشرعية، لا سيما تلك المنطلقة من الشواطئ اللبنانية باتجاه السواحل الأوروبية. ولكي تتفادى عبء هذه “الهجرة”، قررت أوروبا أن ترمي الحمل على كاهل دول أكثر “هشاشة”، وتحديداً على ضفاف المتوسط.
ومقابل أن يتحوّل لبنان إلى شبه “مستودع بشري” للنازحين السوريين، تعهّدت أوروبا بسخاء مادي، كما حصل مع تركيا عام 2016، ثم مع تونس ومصر وموريتانيا في آذار 2024، ضمن اتفاقات واضحة ومعلنة. مساومات مالية مموّهة أُحيطت بلغة “التعاون الإنساني”، لكنها في الحقيقة آتت أُكُلها لصالح القارة العجوز.
وبعد أشهر قليلة فقط، وتحديداً في أيار/مايو 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ضرورة إبداء لبنان “التعاون الإيجابي” لكبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. هذا التعاون كان مشروطاً ومقابل بدلٍ مالي، إذ جرى تخصيص مليار يورو، منها 736 مليوناً لمواجهة تداعيات الأزمة السورية، و264 مليوناً لدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية، خصوصاً في مجال ضبط الحدود.
بيد أنّ هذه الأرقام تبقى (رغم ضخامتها الظاهرية) أقل بكثير من حجم الحاجة الفعلية، حيث تُقدّر كلفة الوجود السوري في لبنان سنوياً بنحو 2 مليار دولار. ومع ذلك، كانت هذه الأموال كافية لإغراء جزء من الطبقة السياسية اللبنانية وتليين مواقفها، إن لم يكن شراؤها بالكامل. وفي المحصلة، لم تعدُ سياسات الاحتواء الأوروبية كونها أكثر من صفقات مقنّعة: استقرار داخلي أوروبي مقابل احتجاز البؤس البشري في الجوار الجغرافي، ولو على حساب التوازنات الاقتصادية والاجتماعية لدول مثل لبنان.
وإن بدت تلك المرحلة بعيدة زمنياً، لا شك بأن آثارها لا تزال سارية المفعول حتى اليوم. فالاتفاق الذي وُقّع في أيار 2024 بين المفوضية الأوروبية ولبنان ينصّ على أن المساعدات المالية ستُصرف على مدى ثلاث سنوات، ما يعني أن البرنامج سيمتد حتى… العام 2027! وهو ما يُفهم منه، ضمناً، أن مسألة إبقاء النازحين السوريين في لبنان قد تقررت حتى ذلك الحين، ما لم تقرّر الحكومة اللبنانية الجديدة، التي شُكّلت مؤخراً، استعادة قرارها السيادي (كما ورد في بيانها الوزاري) وفرض صورة لبنان كدولة قانون تُطبَّق فيها التشريعات، لا سيما تلك التي تنصّ بوضوح على أن لبنان ليس بلداً مضيفاً دائماً، بل محطة عبور مؤقتة.
وللتذكير، هذا ما نصّت عليه “مذكرة التفاهم” الموقَّعة عام 2003 بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، والتي تؤكد على أنّ لبنان ليس دولة لجوء دائمة. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم المفوضية بإعادة توطين النازحين في بلد ثالث خلال فترة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، في حالات استثنائية.
لكن الجميع تجاهل هذا البند القانوني، الذي يُفترض أن يحفظ سيادة البلاد، سواء من الجانب اللبناني الرسمي أو من جانب المجتمع الدولي. وفي مقابلة سابقة مع Ici Beyrouth، صرّح مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية بشكل صريح قائلاً: “صحيح أن احتياجات لبنان تفوق ما يُمنَح له، لكن لا تنسوا أن البلد يستفيد اقتصادياً من وجود النازحين، حيث أن المساعدات التي نقدّمها لهم بالعملات الصعبة، تبقى داخل الأراضي اللبنانية.” وأضاف: “ناهيك عن اليد العاملة التي يمثلها السوريون، فالكثير من اللبنانيين لا يقبلون بالوظائف التي يشغلها هؤلاء”… كلمات كفيلة بإثارة حفيظة وغضب كل من لا يزال يتمسك بكرامة وبمفهوم السيادة الوطنية.
لبنان على حافة الانفجار
بالنسبة للبنان، الذي يرزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ قرن، ينذر استمرار غياب أي خطة لعودة النازحين السوريين بتحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية قد تهدد تماسك الكيان برمّته. وفي هذا السياق، يُحذر أحد المحللين السياسيين اللبنانيين من أن “قدرة المجتمع اللبناني على الاحتمال بلغت حدودها القصوى”.
كما تزداد المخاوف بعد سقوط نظام بشار الأسد وتفاقم التوترات الطائفية والمناطقية في الداخل السوري (لا سيما بين القوى المسلحة الناشئة بقيادة أحمد الشرع، والطائفتين العلوية والدرزية) ما أسفر عن موجات جديدة من النزوح باتجاه لبنان.
وتُظهر بيانات المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن عدد السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بلغ حتى اليوم نحو مليونين وثمانين ألفاً، أي ما يزيد عن نصف عدد سكان لبنان المقيمين، المقدر بأقل من أربعة ملايين. هذا الرقم يثير الاستياء، حسب المستشار السابق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سمير ضاهر، الذي يضيف: “يزداد التوازن السكاني المختلّ اضطراباً بفعل معدل الولادات السنوي المرتفع لدى النازحين، إذ سُجلت نحو 40 ألف ولادة سورية في عام 2023 مقابل 65 ألف ولادة لبنانية، ما يرفع إجمالي الولادات السورية منذ بدء النزوح إلى نحو 280 ألفاً”. ولا تقتصر الكثافة السكانية المتزايدة على السوريين فحسب، بل تشمل أيضاً قرابة 270 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 250 ألف عامل أجنبي من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية، يعملون في قطاعات خدمية متفرقة. وبذلك، يعيش اليوم في لبنان ما يزيد عن 6.5 ملايين نسمة على مساحة لا تتجاوز 10,452 كلم²، ما يرفع الكثافة السكانية إلى حوالي 620 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي من الأعلى عالمياً (باستثناء بعض الأماكن مثل موناكو وسنغافورة وهونغ كونغ).
وفي ضوء هذه المعطيات، ارتفعت بعض الأصوات السياسية الداعية لمراجعة عاجلة لسياسات الاستضافة، بينما طالبت جهات أخرى الأمم المتحدة بوضع خطة منهجية لعودة آمنة ومُنظمة للنازحين إلى سوريا.
ويبقى السؤال الجوهري مطروحاً: كيف سيتعاطى النازحون أنفسهم مع هذه التطورات؟ ففي حين تبدي شريحة منهم، وتحديداً أولئك القادمين من مناطق مدمّرة أو الذين عانوا من الاضطهاد، توّجساً مشروعاً من العودة، باتت فئة أخرى ترى في رفع العقوبات الدولية عن دمشق نافذة أمل ولو ضبابية، للعودة المحتملة.
الأشهر المقبلة ستكون حاسمة والثابت الوحيد: ما عادت المراوحة خياراً مقبولا!
مواضيع ذات صلة :
 الأردن يعلن عودة نحو 18 الف سوري إلى بلدهم منذ سقوط الأسد |  البيان الأول للحزب القومي السوري بعد سقوط الأسد |