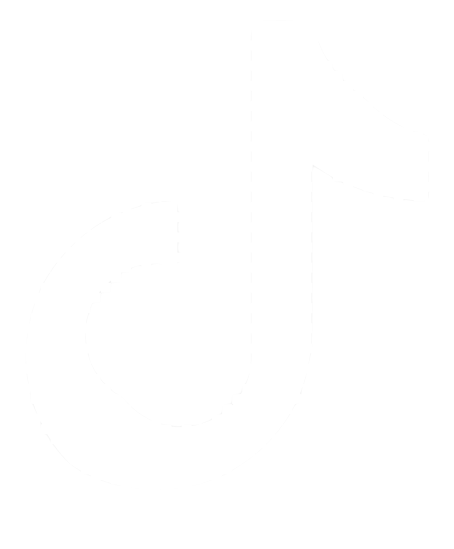ما بعد حزب الله..

ترجمة “هنا لبنان”
كتب Amine Jules Iskandar لـ”Ici Beyrouth“:
بينما تبقى الأنظار مسمّرة على حزب الله، المتهم بتدمير الدولة وتمزيق البلاد وإفقار الشعب، يتسلّل ورمٌ جديد في الظلام وينمو بهدوء وثبات.. يزحف بخطى محسوبة مترصداً الفراغات التي يخلفها الانهيار، نحو المناصب الشاغرة والمؤسسات المتصدّعة والعقارات التي تُباع بثمن بخس في بلد أرهقه الفقر وهجرة الأدمغة والشباب.
هذا الخطر الجديد لا يتجسد بكيان واضح أو بحزب سياسي معين، بل بشبكة منظمات غير حكومية متفرقة، ممولة من مؤسسات مشابهة ترتبط في نهاية السلسلة بمؤسسات “المجتمع المفتوح” (Open Society Foundations) التابعة للملياردير جورج سوروس. وتحمل هذه المؤسسة مشروعاً أيديولوجياً عالمياً يقوم على رؤية يسارية – عولمية تهدف لتفكيك الهويات الثقافية وتحويل المجتمعات إلى فضاءات مفتوحة بلا حدود أو خصوصيات. كما تشير بعض التقارير إلى دخول الصين على الخطّ أيضاً عبر تمويل منظمات ذات التوجه اليساري نفسه.
كارل بوبر والفكر الذي ألهم “المجتمع المفتوح”
الأيديولوجيا التي تروّج لها مؤسسة المجتمع المفتوح (OSF) وشبكتها الواسعة من المنظمات، تستند إلى فكرة عولمة المجتمعات من خلال محو الهويات الثقافية وإلغاء كل ما هو خاص أو محلي. هذا المشروع الفكري يستلهم من الفلسفة التي وضعها الفيلسوف النمساوي كارل بوبر في كتابه الشهير “المجتمع المفتوح وأعداؤه” الصادر عام 1945. ويرى بوبر، الذي ينتقد أفكار أفلاطون بشدة، أنّ المدينة “الفاضلة” التي يحكمها نخبة من الفلاسفة ليست سوى كابوس شمولي يُضحَّى فيه بالفرد لصالح الجماعة. ومع ذلك، ذهب الاتجاه الفكري الذي استلهم من أفكاره والمموّل من جورج سوروس، في الاتجاه المعاكس تماماً: التضحية بالمجتمع من أجل الفرد، وتفكيك كل ما يشكّل هوية جماعية، من الانتماء الثقافي إلى الحدود الوطنية.
وبالنسبة لبوبر، تكمن جذور الأنظمة الشمولية التي طبعت القرن العشرين في الإرث الفلسفي الأرسطي – الهيغلي، الذي يعطي الأفضلية للجماعة على حساب الفرد. وهو يرى أن تجاوز هذه الشمولية يمرّ عبر تحرير الإنسان من قيود الانتماء والهُوية. لكن هذا الطرح يصطدم بإرثٍ آخر: الموروث اليوناني – الروماني والمسيحي، الذي يقوم على التماسك الاجتماعي والروابط العائلية والثقافية. فالمسيحية، التي تضع الأسرة في صلب عقيدتها الاجتماعية، تمثل بالنسبة لأنصار “المجتمع المفتوح” نموذجاً مضاداً. ويزداد هذا الإرث وطأة حين يُقدَّم كامتداد طبيعي للتقليد اليهودي – الإغريقي – الروماني، على حدّ قول المسيح نفسه: “مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ.” (إنجيل متى 5:17).
القطيعة مع الماضي
تقوم فكرة “المجتمع المفتوح” على القطيعة مع الماضي ويبجل أنصاره فكرة “البدء من الصفر” أو ما يُعرف بـ”الصفحة البيضاء” (la table rase). فالماضي الغربي، في نظرهم، يجب أن يُمحى لأنه ملوث بكل “الآثام” والشرور: فهو ذكوري واستعماري وعنصري وفاشي. وتُحوّل هذه النظرة التاريخ إلى “خطيئة أصلية” لا بد من التكفير عنها، وتُحوّل الماضي إلى عدو مطلق. والمفارقة أنّ هذا الفكر يلتقي جزئياً مع المنطق الأصولي الإسلامي، الذي اعتبر كل ما سبق ظهور الإسلام “جاهلية” يجب القضاء عليها.
ومن حيث المبدأ، يرى كارل بوبر أنّ المجتمعات التقليدية المغلقة لا بدّ أن تتطور نحو مجتمعات منفتحة، تقوم على التبادل والانفتاح الثقافي. وهو يعتبر أنّ هذا التطور مسار طبيعي وتدريجي لا عودة عنه. لكن حين تحوّل هذا الفكر إلى أيديولوجيا تُفرض بالقوة أو بالمال، خرج عن مساره الفلسفي وأصبح مشروعاً يزرع الفوضى بدل التقدم، ويهدم البنى الاجتماعية بدلاً من تطويرها.
بيد أنّ المشكلة الأعمق، كما يحذر كثيرون، تكمن في أنّ هذا النموذج يُفرض حصراً على المجتمعات ذات الجذور المسيحية، وكأنّ المطلوب إعادة تشكيلها ثقافياً وأخلاقياً تحت ستار “الانفتاح” و”الحرية”، فيما تُستثنى منه حضارات أخرى ذات بنى تقليدية أكثر تشدداً. وهنا يطرح سؤال جوهري: هل ما يجري مشروع إنساني فعلاً، أم هندسة اجتماعية انتقائية؟
وعلى الرغم من أنّ بوبر نفسه كان يعتبر المدينة الفاضلة عند أفلاطون مجرد “يوتوبيا” سياسية، تحول الفكر الذي يستلهم فلسفته اليوم للمفارقة، هو الآخر، إلى يوتوبيا جديدة، تسعى لخلق عالم بلا جذور وبلا ذاكرة وبلا هوية. والأسوأ أنّ المنظومة التي ترفع شعار “المجتمع المفتوح” تمارس داخل الجامعات والمؤسسات أشكالاً من الشمولية الفكرية، إذ تُقصى كل الأصوات المخالفة ويُوصم أصحابها بـ “المتطرفين” أو “غير الأكاديميين”.
وبعد أن بدأت نشاطاتها في أوروبا الشرقية وساهمت فعلاً في تحرّرها من الأنظمة الشيوعية، تحوّلت وجهة هذه الحركة نحو الغرب نفسه. وهي تسعى اليوم، لتفكيك الانتماءات الوطنية والدينية والعائلية، ولتحويل الفرد إلى كيان معزول لا رابط له سوى القانون. غير أنّ المفارقة الصارخة تكمن في أنّ هذه الحركة التي ترفع لواء المساواة تمارس، تحت تأثير الفكر “الووكي” (woke)، تمييزاً عنصرياً مقلوباً باسم العدالة الاجتماعية، مما يخلّ بالتوازن الذي كانت تنادي به أصلاً.
ماذا عن لبنان؟
في الحالة اللبنانية، تبدو هذه الحركة الفكرية أخطر من غيرها، لأنها تتحرك بهدوء وبشكل يصعب كشفه. فأنصارها لا يدركون أصلاً أنهم يروّجون لأيديولوجيا “الووك” (wokisme)، إذ يعتقدون أنهم يسعون حصراً لتحديث المجتمع ومحاربة النظام الطائفي القديم. لكنهم يساهمون، من حيث لا يدرون، بتفكيك النسيج اللبناني الذي بُني على التنوّع والانتماء. هؤلاء الناشطون يرون في النظام الطائفي اللبناني “تخلّفاً قبلياً” يجب تجاوزه للوصول إلى “مجتمع مفتوح” قائم على المساواة والحرية. غير أن نشاطهم يتركّز في الوسط المسيحي تحديداً، لأنهم يعتبرونه العقبة الأكبر أمام هذا التحوّل، بوصفه بيئة محافظة ومتمسكة بهويتها التاريخية.
وللتذكير، دخل لبنان بعد الانهيار الاقتصادي عام 2019، مرحلة جديدة فتحت الباب واسعاً أمام المنظمات غير الحكومية. ومع تراجع قدرة العائلات والمؤسسات على الصمود، أصبحت هذه المنظمات المموّل الأساسي للمدارس والجامعات والمراكز الإعلامية المسيحية. وهنا بدأ التأثير الأيديولوجي يظهر: المال مقابل النفوذ الفكري. فبفضل الدعم المالي، تمكّن أساتذة وإداريون مرتبطون بهذه الجهات من فرض حضورهم داخل الجامعات ونشر فكرهم الحداثي المستورد، الذي يروّج لمفاهيم مغايرة للثقافة اللبنانية التقليدية.
كما تركت بعض هذه المنظمات، رغم نفيها الارتباط بـ”المجتمع المفتوح”، بصمات واضحة في السياسة والقطاع المصرفي. إذ روّجت لشعارات مثل “كلّن يعني كلّن”، فخلطت بين الفاسدين والإصلاحيين وطمست النقاش حول جوهر الأزمة السياسية المتمثلة بسلاح حزب الله، مركّزة على شعار “مكافحة الفساد” وحده. كما أنّ بعض هذه المنظمات أقامت علاقات تواطؤ أو مجاملة مع الحزب نفسه.
باب التعليم والإعلام
وفي قلب الجامعات اللبنانية، تدور اليوم معركة خفية لا تقل خطورة عن أية مواجهة سياسية أو عسكرية. وبدأت هذه المنظمات بإضعاف القطاع المصرفي عبر سياسات مشبوهة هدفت إلى تفكيكه واستبداله بنظام مالي خاص بها. ثم اتجهت نحو ممتلكات الدولة، ساعية إلى شرائها بأسعار زهيدة تحدّدها هي نفسها عبر لجان أكاديمية داخل جامعات مرموقة تستمد منها شرعيتها. ومع الوقت، تمكنت من اختراق أجهزة الدولة والإعلام عبر شبكة من العلاقات مع بعض النافذين والفاسدين، لتصبح لاعبًا حقيقيًا خلف الكواليس.
من خلال قنوات تلفزيونية ومنصّات رقمية تموَّل علنًا من مؤسسات مثل “المجتمع المفتوح”، وسّعت هذه الجهات نفوذها الثقافي والإعلامي. وباتت جوهها مألوفة على الشاشات اللبنانية والفرنسية، حيث يظهر مسؤولوها في البرامج السياسية والندوات وحتى في البرلمان الفرنسي، يتحدثون باسم الانفتاح و”حقوق الإنسان”.
وتسعى هذه الشبكات للهيمنة على كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات المسيحية، بوصفها مصانع النخب المستقبلية. وهناك يجري العمل على إعادة تشكيل العقول وفق فكر “عالمي” لا يعترف بالهوية أو الخصوصية الثقافية، ويُعيد كتابة التاريخ بنبرة جلد الذات. كل ذلك بأسلوب أكاديمي راقٍ، يستخدم لغة القانون والمنطق.
أما الأساتذة أو الباحثون الذين يجرؤون على انتقاد هذا المسار، فمصيرهم التهميش أو الإقصاء بحجة “عدم الانضباط الأكاديمي”، فيما يُجبر المستقلون منهم على الصمت لأنّ السلطة بيد الممولين. ومع الوقت، تُخضَع الجامعات والإعلام بالكامل لهيمنة فكرية واحدة ولمنبر أيديولوجي واحد، يُعاد عبره تشكيل وعي الشباب. وهكذا، يصبح الجيل الصاعد بين خيارين: إما الانخراط في فكر لا يشبهه، وإما التيه في الفراغ الفكري.