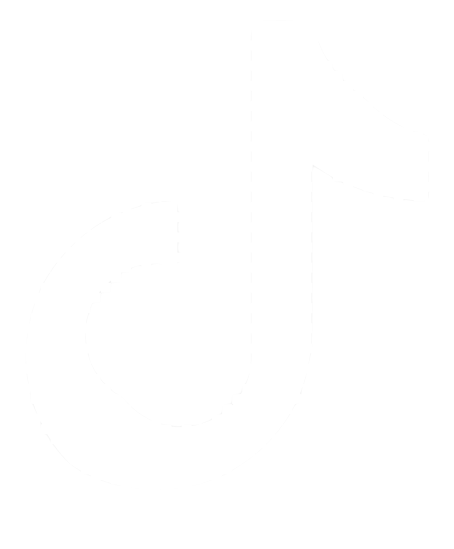لبنان أسير صدمة جماعية ترتجي السلام

كتب Salam El Zaatari لـ”This Is Beirut”:
المشهد اللبناني يعكس التناقض العميق بين الإمكانات الوطنية الكبيرة والواقع السياسي المأزوم. ففي بلد يزخر بالكفاءات والطموحات، لا يخفى العجز عن توجيه الدفة بفعل الانقسامات المزمنة واهتزاز البوصلة الوطنية.
ففي مشهد لافت، أحيا الشارع السني الإثنين الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، وسط احتفالات حملت في طياتها مفارقة سياسية واضحة. فالطائفة التي لطالما انتقدت خصومها بسبب تقديس الزعامات الإقليمية، وجدت نفسها منخرطة في سلوك مماثل عبر إضفاء طابع رمزي مبالغ فيه على القيادة السورية الجديدة.
الاستعراضات بالدراجات النارية التي جابت شوارع بيروت وطرابلس وصيدا أبعد من احتفالات عابرة. لقد شكلت صورة مكثفة عن واقع لبناني مأزوم، حيث تتشابه الطوائف في ممارساتها السياسية رغم خطابها المتناقض. وهكذا، وقف لبنان من جديد أمام مرآة تعكس أزمة هوية عميقة، في بلد بات يكرر أخطاءه بأسماء وشعارات مختلفة.
في الشارع المؤيد لحزب الله، كشفت ردود الفعل عن استمرار نهج الإنكار السياسي، حيث اختلطت الشعارات التحريضية بمحاولات استعراض القوة، من دون أي استعداد للاعتراف بمسؤولية السياسات السابقة في تعميق الانهيار اللبناني. فالمشروع الذي قام على النفوذ الإقليمي وبناء سلطة موازية للدولة لم يعد مصدر قوة، بل تحوّل إلى عبء ثقيل على الحزب وبيئته على حد سواء.
وفي ظل غياب المراجعة، اتجه الحزب نحو تصعيد الخطاب وتحريك الشارع، مستحضرًا مخاوف الحرب الأهلية كأداة ضغط. لكن هذا المسار يحمل للمفارقة تناقضًا واضحًا، حيث أنّ الجهة التي تلوّح بالصدام تبدو اليوم الأقل قدرة على تحمّل كلفته وتداعياته.
ويعكس هذه الوقائع مأزقًا وطنيًا أعمق، حيث يبدو وكأنّ لبنان يصرّ على السير عكس مصالحه، على الرغم من توفر فرص حقيقية للإنقاذ. أربعة عقود من الأزمات المتراكمة حوّلت الطاقة الخلّاقة لنزعة تدمير ذاتي، ليغدو الاستقرار والسلام الخيار العلاجي الأخير المتاح.
وعلى الرغم من قتامة المشهد، يبقى التميّز اللبناني حقيقة لا يمكن إنكارها. ففي رقعة جغرافية محدودة، أنتج لبنان كثافة استثنائية من الكفاءات التي تركت بصمتها في الطب والهندسة والتعليم وريادة الأعمال حول العالم، وهذا يؤكد أنّ الأزمة لا تكمن في اللبناني نفسه، بل في النظام الذي يعطّل إمكاناته.
والجدير بالذكر أنّ المجتمع اللبناني يتمتع بخصائص نادرة في محيطه، أبرزها التعدد اللغوي والثقافي المتوارث بسلاسة لافتة بين الأجيال. وفي الحياة اليومية، يمكن لأي عامل أو سائق أو طالب أن يعكس مستوى من الوعي والمعرفة يتجاوز الصور النمطية، حيث تختلط اللغات بالنقاشات السياسية والفكرية، ويصبح الاطلاع على الشأن العام جزءًا من الثقافة الشعبية.
غير أنّ هذه الوفرة في القدرات الفردية تصطدم بواقع وطني مأزوم. فلبنان، الذي يصدّر كفاءاته للعالم، يعجز عن استثمارها داخليًا، وكأن هناك ميلًا جماعيًا لإعادة إنتاج الفشل. هذا التناقض لا يُفهم بمعزل عن المسار النفسي للتجربة اللبنانية الحديثة، التي اتسمت بتراكم الصدمات بدلاً من معالجتها.
فالحرب الأهلية أكثر من مجرد صراع عسكري. لقد شكّلت استنزافًا نفسيًا طويل الأمد استمر خمسة عشر عامًا. وبعد توقف الاقتتال، لم يدخل البلد في مرحلة استقرار حقيقي، بل انتقل من عنف مباشر إلى أزمات متلاحقة شملت الاغتيالات السياسية والفساد المنهجي والنزاعات الإقليمية على أرضه بالإضافة إلى تفكك مؤسسات الدولة. ثم أتى انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ليصيب مجتمعًا منهكًا أصلًا، غارقًا في إرهاق نفسي جماعي يعصى استيعاب تبعاته على أي مجتمع.
دراسات علم النفس السياسي تُظهر أنّ المجتمعات التي تختبر فترات طويلة من الاضطراب لا تنجو منها بسهولة. فمع مرور الزمن، تتحول خيارات الناس من قرارات عقلانية إلى ردود فعل محكومة بغريزة البقاء. وفي هذا السياق، يبرز الميل للتمسك بزعامات مألوفة تُقدَّم بوصفها مصدر أمان، حتى عندما تكون جزءًا من المشكلة، فيما يصبح التفاهم مدعاة للقلق، والثقة مخاطرة غير محسوبة.
في السياق اللبناني، وبعد عقود من الأزمات المتتالية، يمكن رصد نمط سلوكي عام لا يميّز بين طبقة وأخرى. مواطنون يعانون من قلق دائم وانقسام في الثقة وانجذاب إلى الانتماءات الضيقة، مع تفكير حاد يقوم على منطق الغلبة لا الشراكة، وانفعالات سريعة تطغى على الحسابات البعيدة المدى. تلك هي سمات مجتمع أنهكته الصدمات ولم تتح له فرصة التعافي.
وينسحب هذا الواقع مباشرة على الحياة السياسية، حيث يعجز النظام عن إنتاج استقرار مستدام. فالمجتمع، رغم وعيه وقدرته على التحليل، يتحرك بردّات فعل متتالية، ما يجعل الساحة السياسية أقرب إلى مساحة توتر دائم منها إلى ساحة إدارة شؤون عامة.
وفي قلب هذا المشهد، ينقسم اللبنانيون إلى معسكرين متواجهين، تحكم العلاقة بينهما مشاعر عداء متوارثة أكثر مما تحكمها اختلافات برامجية. الاتهامات المتبادلة بالخيانة والفساد والارتهان للخارج لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل تعبير عن جراح نفسية عميقة غير معالجة. وبين حقيقة جزئية ووهم جماعي، يبقى الطرفان عالقين في صراع هوية، حيث يتقدّم الانتماء على المصلحة الوطنية، ويُؤجَّل الخلاص إلى أجل غير معلوم.
وفي سياق متصل، تظهر النظريات الاجتماعية أنّ انهيار الدول لا يبدأ دائمًا من الاقتصاد أو السياسة، بل من تفكك الثقة. فعندما تضعف المؤسسات، يلجأ الأفراد إلى الجماعات الضيقة، وحين يتراجع الأمن، تصبح الهوية ملاذًا بديلاً عن العقل، وبغياب الدولة، تتقدّم السرديات على الوقائع. ويقدم لبنان في هذا الإطار، نموذجًا شبه مثالي لهذا المسار.
منذ نهاية الحرب الأهلية، طارد شبح الخوف المتراكم القرارات الكبرى، وغابت الرؤية المستقبلية. وساهم هذا الخوف بترسيخ طبقة سياسية متهمة، وشرعنة الفساد وإعادة تدوير قيادات عاجزة وتوفير الحماية لمن قدّموا أنفسهم كحماة للطوائف بدل أن يكونوا خدامًا للدولة. لم يأتِ الانهيار وليد الصدفة، بل حصيلة وعي جماعي مثقل بالصدمة.
هذا الواقع يفسر التناقض اللبناني المزمن: بلد غني باللغات لكنه فقير في تعريف مصلحته الوطنية، مليء بالخبراء لكنه غارق في انهيار مالي غير مسبوق، نابض بالتبادلات والنقاشات السياسية لكنه عاجز عن إدارة أبسط الخدمات العامة. إنها أزمة إدارة نفسية قبل أن تختزل بأزمة موارد.
واليوم، يقف لبنان ضمن دائرة مغلقة من الأزمات المتتالية. كل منها تولّد قلقًا عامًا، وكل قلق يدفع إلى قرارات انفعالية. ثم تعيد هذه القرارات إنتاج الأزمات بشكل أكثر حدّة. الطاقات موجودة، لكن آلية التوجيه معطوبة، ما يجعل القدرة تتحول إلى عبء بدل أن تكون فرصة.
في المحصلة، الخطر الأكبر على لبنان لم يكن خارجيًا بقدر ما نبع من الداخل. فغياب مصالحة وطنية حقيقية بعد الحرب الأهلية ترك جراحًا مفتوحة انعكست على سلوك الدولة والمجتمع. من هنا، يصبح السلام مشروع إعادة بناء نفسي بقدر ما هو خيار سياسي، ويتضح أنه جسر عبور ضروري للانتقال من مجتمع يعيش على غريزة النجاة إلى دولة قائمة على المواطنة والاستقرار.