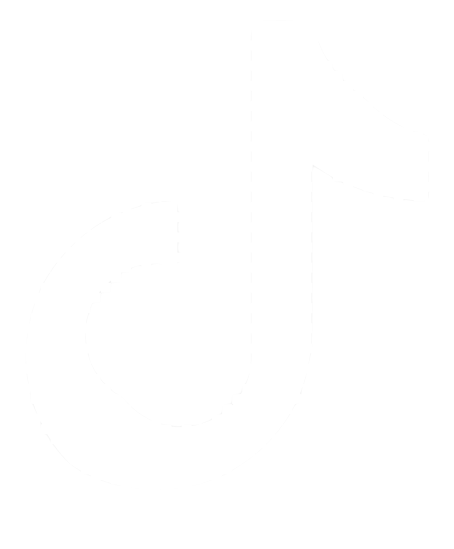“قانون الفجوة المالية”.. بلغة مبسطة

كتب Mario Chartouni لـ”Ici Beyrouth”:
“قانون الفجوة المالية”.. عبارة تتردد منذ أشهر في الكواليس السياسية والمالية وكأن بها مفتاح الحل السحري للأزمة المصرفية في لبنان. القانون يُقدَّم للرأي العام على أنه طوق النجاة المنتظر: يعيد الانتظام إلى النظام المالي المتهالك، ويفتح باب الخلاص نحو اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي.
ولكن هل تحمل هذه العبارة التقنية فعلاً مفتاح الحل… أم تراها تخفي حقيقة أكثر قسوة؟ هل سيساعد هذا القانون المودعين حقاً على استرجاع أموالهم؟ أم سيكتفي بتشريع ما تكبدوه من خسائر منذ العام 2019؟
فجوة مالية تتجاوز 70 مليار دولار
“قانون الفجوة” ينطلق من مفهوم أساسي يُعرف بالفجوة المالية: أي الفرق بين ما تلتزم المصارف بدفعه للمودعين، وما تملك فعلياً القدرة على تسديده. وحسب التقديرات الأولية للحكومة، بلغ هذا العجز نحو 70 مليار دولار، وهو رقم مرشّح للارتفاع بعد ست سنوات من أزمة عالقة دون أي معالجة فعلية، ما جعل الفجوة أعمق وأكثر كلفة مع مرور الوقت.
بالنسبة لوزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم، الصورة واضحة ولا تحتمل التأويل: “يفترض بقانون الفجوة أن يضع إطاراً قانونياً لتوزيع الخسائر بين أطراف الأزمة اللبنانية كافة: الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين بشكل غير مباشر”.
بعبارات أخرى، لا يتعلق الأمر بخطة نهوض أو مشروع إنقاذ، بل بنص قانوني هدفه تنظيم إفلاس شامل، يسعى لـ”تفريغ أزمة نظامية بأسرع وقت ممكن، تمهيداً لتقديم ميزانية قابلة للتسويق أمام صندوق النقد الدولي”.
قانون توزيع خسائر… لا قانون إعادة أموال
وخلافاً لما يروَّج في الخطاب السياسي، لا يخلق قانون الفجوة أموالاً ولا يستحضر السيولة من العدم. وتقتصر مهمته على الاعتراف المحاسبي بالخسائر وتحديد كيفية توزيعها. وحسب حكيم، يجب على أي قانون يتمتع بالحد الأدنى من المصداقية أن يقوم على ركيزتين واضحتين: “الاعتراف المحاسبي الكامل بالخسائر المتحققة، ووضع آلية حقيقية لإعادة الودائع”.
لكن الواقع يُظهر أنّ هاتين الركيزتين غير مثبتتين بشكل جدي حتى الساعة.
الأرقام وحدها كفيلة بكشف حجم المأزق. فوفق كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، لا تتجاوز السيولة المتاحة 14.2 مليار دولار، وهو مبلغ أبعد ما يكون عن تلبية الحاجة الفعلية، إذ يتطلّب سداد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار وحدها نحو 22 مليار دولار.
أما النسخة التاسعة المسرّبة من مشروع القانون، فتنص على تسديد الودائع حتى 100 ألف دولار نقداً على مدى أربع سنوات، دون أي تحديد واضح لمصدر التمويل. أما بخصوص ما تبقّى، فيُمنح المودعون سندات صادرة عن مصرف لبنان بفائدة 2%، تُستحق بعد 10 أو 15 أو 20 سنة بحسب الشرائح. وهنا يطرح غبريل السؤال الجوهري:”من أين سيؤمّن مصرف لبنان السيولة اللازمة للسداد بعد 10 أو 15 أو 20 عاماً؟”. ويضيف: “الإجابة لا تزال غامضة تماماً”.
الدولة خارج المعادلة… والمصارف تحت الضغط
مقاربة الحكومة ترتكز على مبدأ صارم: الدولة لن تساهم مباشرة في سدّ الفجوة المالية. غير أنّ هذا التوجّه، حسب الوزير السابق، يحمل إشكالية جوهرية.
“من دون مشاركة الدولة من ميزانيتها، وهي المسؤول الأول عن الانهيار نتيجة تراكم الديون، يُنقَل عبء إعادة الهيكلة تلقائياً إلى المصارف… ثم إلى المودعين”. فمعظم مستحقات المصارف لدى مصرف لبنان هي في حقيقتها أموال المودعين أنفسهم. كما تنصّ المادة 13 من قانون النقد والتسليف بوضوح على أنّ هذه التوظيفات تُعد التزامات تجارية قانونية. وبالتالي، لا يعتبر أي تخفيض في قيمتها أو شطب جزئي لها إجراءً تقنياً بريئاً، بل مصادرة غير مباشرة للمدّخرات، مقنّعة بخطاب عن إعادة التوازن إلى الميزانيات المالية.
شبح الإفلاسات المصرفية
كما حذّر حكيم من أنه “حين تُصفّى حقوق المساهمين من دون أي آلية لإعادة الرسملة، يدفع القانون نحو إفلاسات تقنية وربما فعلية”. وبدوره، أكد غبريل المخاوف نفسها: “نعم، هناك خطر حقيقي بإفلاس مصارف وفق المسودة التاسعة لمشروع القانون”.
وذكّر بأن المصارف كان بإمكانها إعلان الإفلاس منذ البداية، تاركة للمودعين “الفتات”. “لكنها لم تفعل”. إلا أنّ الإبقاء على الصيغة الحالية قد يدفع بعضها لإعادة التفكير بهذا الخيار.
وفي ظل الضبابية السياسية المزمنة، يبدو استقطاب رساميل جديدة لإعادة رسملة المصارف مهمة شبه مستحيلة. يتساءل حكيم “من الذي سيغامر بالاستثمار اليوم؟”، مشيراً بوضوح إلى العقدة العالقة المتمثّلة بسلاح حزب الله، وإلى مسلسل المماطلة والتجاذبات السياسية التي لا تنتهي.
وبرأيه، لا يمكن الحديث عن تحسين مناخ الاستثمار إلا إذا انضمّ لبنان إلى “الدول العربية المعتدلة التي تتجه اليوم نحو رؤية إقليمية جديدة وشاملة”، ما قد يفتح الباب أمام استعادة الثقة والرساميل.
الذهب… رافعة استراتيجية مُهمَلة
احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان قفزت من 13.9 مليار دولار نهاية 2019 إلى 38.4 مليار دولار نهاية نوفمبر 2024، وحدث ذلك فقط نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وليس عبر أي سياسات مالية أو استراتيجية وطنية. آلان حكيم يرفض تماماً فكرة تسييل الذهب أو بيعه، معتبرًا ذلك اعترافاً صريحاً بفشل هيكلي. ويقترح في سياق البديل توظيف الذهب عبر أدوات مالية مبتكرة، يمكن من خلالها تعبئة نحو 10 إلى 14 مليار دولار لدعم السيولة دون التفريط بالذهب الفعلي.
أما غبريل، فيذهب أبعد من ذلك، محذراً: “لا يجوز التعامل مع الذهب كلوحة جميلة معلّقة في متحف”. وهو يقترح لذلك استثمار الزيادة التي بلغت 24.5 مليار دولار عبر القروض المضمونة بالذهب، ما يسمح بضخ نحو 12 مليار دولار في الاقتصاد من دون بيع الذهب فعلياً. والحجة قوية: مع احتياطيات (ذهب + عملات) تعادل 119% من الناتج المحلي، يمتلك لبنان أعلى نسبة في العالم، متقدماً حتى على سويسرا (100%).
من يدفع الثمن أخيراً؟
وراء كل التعقيد التقني والمصطلحات المحاسبية، يبقى السؤال الأساسي بسيطاً ومؤلماً: من الذي سيدفع الثمن؟ وطالما الدولة ترفض المشاركة، والمصارف تؤكد عجزها، يبدو أنّ المودعين هم الحلقة الأضعف والضحية الأساسية في عملية توزيع الخسائر.
بهذه الصيغة، لا يقدّم “قانون الفجوة” حلاً حقيقياً للأزمة، بل يسعى لجعلها مقبولة قانونياً، بعيداً عن معالجة جذورها: الفساد المستشري واستدامة الهدر وانعدام إنتاجية الدولة.
مواضيع ذات صلة :
 بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع! |  هبوط حاد للذهب والفضة |  أسعار متقلبة وطلب مرتفع… سوق الذهب في حالة ترقّب! |