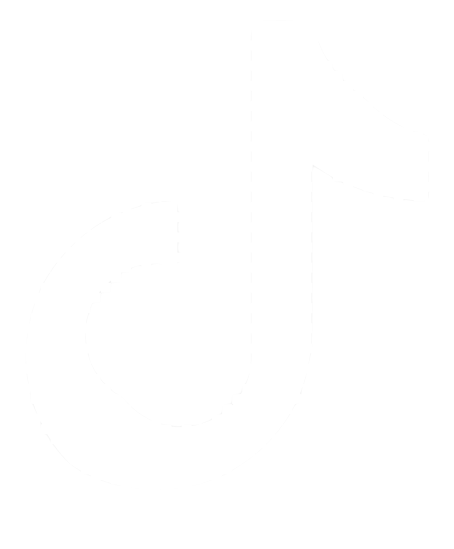نتعايش ولكن ليس لدرجة الموت!

كتب يوسف معوّض في “Ici Beyrouth“:
على الرغم من أن ميثاقنا الوطني شكل مصدر إلهام للعراقيين في العام 1943، إلّا أنه فقد رونقه في لبنان وما عادت صيغته التي أطّرت العيش المشترك متكيفة مع الوضع الحالي. فهل حان الوقت لإيجاد البديل؟!
شكل ميثاق 1943 محط تهكم بالنسبة للكاتب دانيال بيريسنياك. على الرغم من تفرده، كإحدى الصيغ الأكثر دهاء لإدارة المجتمعات المتعددة الطوائف وتحقيق التوازن بين الطوائف. فتساءل المراقب الجمهوري المتشدد كيف تحكم الحصص الدينية كل شيء في بلدنا. واستنكر بشكل مبرر، كيف أنه في لبنان “لا يصبح المرء وزيراً أو نائباً أو قاضياً أو مديراً لمدرسة بفعل كفائته، وإنما بفضل المحسوبيات الدينية. وهذا ما يحدث عندما تعترف المؤسسات بـ “أولوية الإنتماء الطائفي على الفرد”.
ولكن مع ذلك، بدا أن لصيغة تقاسم السلطة هذه، بغض النظر عن كونها قابلة للنقاش، بعض المزايا. وهذا ما دفع ببعض مروجيها باقتراح تقليدها في العراق المحرر من صدام، حيث تم تبنيها للخروج من الأزمة، بغياب مخارج الطوارئ الأخرى. وهكذا، في “بلاد ما بين النهرين” اليوم، رئيس الجمهورية كردي بينما رئيس البرلمان سني ورئيس مجلس الوزراء شيعي. قد يبدو نظام الترويكا هذا سخيفًا وغير معقول في نظر العلمانيين، ولكنه يمثل مع ذلك مهرباً أو نافذة مؤقتة للحل بغياب أي بديل أفضل لممارسة السلطة. وعلى أي حال، بإمكانه ترسيخ مظهر من مظاهر سيادة القانون؛ وهو الحل الأفضل عوضاً عن استمرار حالة الاقتتال العلنية أو الخفية بين الطوائف، والتي تعود جذورها لأحداث كربلاء في العام 61 للهجرة أو المجازر الطائفية في بغداد عام 444 للهجرة.
هل وجد لبنان الحل لخلافاته؟ وهل يمكن لصيغتنا السحرية أن تحلّ بدورها مسألة كوسوفو أو سراييفو في البوسنة والهرسك، على سبيل المثال؟
التعايش ليس أكثر من إجراء مؤقت
فلنعد إلى نقطة البداية: بصفتنا أشخاصًا يشاركون في تسيير شؤون الدولة، لسنا أكثر من مواطنين مشتتين اجتماعيًا. ولا يكفي أن البعض منا تحول للعلمانية والاستقلال إلى حد كبير، لإلغاء حقيقة أن السواد الأعظم من اللبنانيين لم يتنصلوا بعد من انتمائهم الطائفي أو من الهوية المستمدة منه. هوية عادة ما يكتسبها الفرد عند الولادة ويتشربها مع انغماسه في المجموعة التي ينتمي إليها. وهي هوية طبعتها قرون من الاختلاط البشري والصراعات الدموية التي بقيت ذكراها محفورة في الذاكرة الجماعية لكل فريق. تلك هي الهوية التي تميز مواطنينا عن بعضهم البعض.
في عصر العولمة والشفافية والتمازج الثقافي، ليس من الصحي إخفاء حقيقة أن الوئام التاريخي، الذي تتباهى به المجتمعات المتنوعة، عرف لحظات من التمييز وصولاً للاضطهاد. وينطبق ذلك على جميع الدول العربية الإسلامية دون استثناء.
فلنعترف إذاً بحقيقة أن التعايش الوطني يبدو في بعض النواحي، مجرد إجراء مؤقت.
الأمة اللبنانية ليست موحدة
قالها أنطوان مسرة، الذي حرص دوماً على الحفاظ على الصيغة اللبنانية، مشيراً إلى أنه “لو أن التعايش الوطني كان مشروعا متبادلاً لترجم بدولة وبمجتمع. فالمجتمع لا يختزل بإضافة للأفراد بل هو مجموعة بشرية تحكمها القوانين وهو العقد الاجتماعي الذي يجعل الحياة المشتركة ممكنة”. ولكن انطلاقاً من شغفه الوطني الذي يعرف به، لا يود الأستاذ الفخري الاعتراف بأن الأمة اللبنانية ليست موحدة، وبأن المكونات المذهبية لشعبنا لا يمكنها تجاوز الاختلافات في الأصول الدينية وأن شرائح كبيرة من السكان ترفض ما يسمى بـ”العقد الاجتماعي” للطائف بقصد فرض قوانينها وتعزيز مصالحها.
ذلك أن نظامنا المركزي، الموروث من الانتداب الفرنسي، عرضة للتدهور لأسباب اقتصادية. هل يجب التذكير بأننا تحت الاحتلال وبأن البندقية موجهة إلى رؤوسنا؟ وهذا ليس كل شيء، فــ”مركب الدولة” عرضة للغرق لأسباب هيكلية. لبنان بلد التبعية ليس سويسرا، ولا يمكن لنظامنا السياسي أن يسعى في الوقت عينه لتحقيق هدفين متناقضين، هما الحفاظ على خصوصيات المجتمع من جهة وبناء المواطنة من خلال الانتماء الفردي والطوعي من جهة أخرى.
في المرحلة التي وصلنا إليها، لا بد لنا أن نقرر ما الذي لا يمكن إصلاحه: بفعل التسويات التي خضع لها، ما عاد بالإمكان استخدام الميثاق الوطني (بنسخة الطائف). ومن هنا يبرز الصراع الخافت بين مختلف مراكز صنع القرار والعراقيل الدستورية المتكررة. لذلك، دعونا نجد صيغة أخرى لأن التعايش الوطني قد استنفد زخمه في إطار الكليشيهات الرسمية وبدأ يثقل كاهلنا.
إسقاط بسيط
في فجر الاستقلال، استلهم مشروع الطبقة السياسية الغالبة من نموذج الغرب الليبرالي مع توفير الضمانات للأقلية المسيحية تاريخياً في الشرق العربي الإسلامي. لم يخل هذا النموذج من العيوب وأوجد اختلالات طائفية وأدام حالة الظلم الاجتماعي، ولكن مع ذلك، أمكن للجميع الاستفادة منه. والأهم من ذلك، لم تكن الدولة قمعية في ظله. أضف إلى ذلك أنه أكسبنا التناوب في السلطة، وبالنتيجة، لن تكون الآفاق السياسية مسدودة على غرار ما حصل في البلدان المجاورة حيث أدت الانقلابات بشكل دروي لفرض أنظمة رعب بشكل متكرر.
ولكن لسوء الحظ، واجه مشروع آبائنا المؤسسين الإعتراضات ولم ينج اتفاق الطائف الذي سعى لمنحه نفحة من الحياة، من تخريب المحتل السوري، ومن ثم من قبل الطائفة الشيعية. وذلك، لأن حزب الله لم يستطع تحمل الصيغة اللبنانية إلى أجل غير مسمى. واستفاد الحزب من انتصاراته الإلهية المزعومة، لضمان وضع اليد على الدولة، والتغلغل فيها على جميع المستويات. ومنذ ذلك الحين، تمكن الحزب بسهولة من تنفيذ سياسات العرقلة الخاصة به من أجل تحقيق أهدافه. ولا يبذل حزب ولاية الفقيه جهداً ليخفي مفهومه الخاص عن الدولة. وعلى أي حال، لا يشبه نموذجه في الحكم أي من قيم الغرب الليبرالي الذي اخترناه مثالاً منذ البداية.
من الواضح أن نظام الملالي الذي أبصر النور في مدينة قم، لا يحظى بإجماع اللبنانيين تماماً كما لا يحظى بإجماع الإيرانيات الشجاعات، اللواتي خلعن عن رؤوسهن الحجاب في شوارع المدن الإيرانية.
لذلك دعونا نجد بديلاً آخر. ودعونا نتذكر أن الفيدرالية هي الحرية.
مواضيع ذات صلة :
 تعطيل الدستور والعيش المشترك |